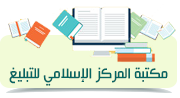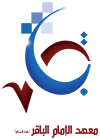الحمدُ للهِ الذي خلقَ الإنسان، وكرّمهُ بالعقل والبيان، وامتنّ عليه بنعمة الاجتماع والعمران، وأشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، جعل حُسن الجوار من كمال الإيمان، وأشهد أنّ محمّداً عبدُه ورسولُه، أرسله بدين الهدى، وأدّبه فأحسن تأديبه، حتّى صار سيّد مَن أحسن الجوار وعفا عند المقدرة.
اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّد، الهداة المهديّين، والراحمين بالخلق، ولا سيّما بقيّة الله في أرضه، روحي وأرواح العالمين له الفداء!
إلى مولانا صاحب العصر والزمان (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء)، وإلى نائبه وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه)، وإلى شهيدنا الأسمى سماحة السيّد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، وإلى مراجعنا وقادتنا العظام، وإلى الأمّة الإسلاميّة جمعاء، نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك بذكرى ولادة الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام).
ولادة النور الرضويّ
أيّها المؤمنون، نلتقي اليوم في رحاب مناسبة مباركة من مناسبات أهل البيت (عليهم السلام)، ألا وهي ذكرى ولادة الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام)، الذي أشرقت الدنيا بولادته، وأزهرت الأرض بعلمه وأخلاقه ومقامه الشريف.
وُلد الإمام الرضا (عليه السلام) في الحادي عشر من شهر ذي القعدة، سنة ١٤٨هـ، في المدينة المنوّرة، في بيت طاهر من بيوت الوحي، وترعرع في كنف الإمامة، يحمل من جدّه أمير المؤمنين صلابة الحقّ، ومن جدّته فاطمة الزهراء نقاء الروح، ومن أبيه الكاظم (عليه السلام) عمق الصبر وعلوّ البصيرة.
وفي الإشارة إلى هذه الصفات وأثرها على التشيّع، يقول الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه)، متكلّماً على حساسة المرحلة التي عاش فيها الإمام الرضا (عليه السلام)، وكيف أنّه استطاع بأسلوبه الحكيم أن يجعلها من أهمّ المراحل بركةً وثمرة: «واجه الإمام الثامن عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام) تجربةً عظيمةً في معرض حرب سياسيّة خفيّة، تحدّد نتيجتُها انتصارَ مصير التشيّع أو هزيمتَه... لكنّ الإمام الثامن (عليه السلام)، وبالتدبير الإلهيّ، تغلّب في ذلك الميدان... وكانت سنة 201 للهجرة من أكثر سنوات تاريخ التشيّع بركةً وثمرة... كلّ ذلك ببركة التدبير الإلهيّ للإمام الثامن (عليه السلام) وأسلوبه الحكيم»[1].
لقد عُرف الإمام الرضا (عليه السلام) بسعة العلم، حتّى لُقّب بـ«عالم آل محمّد»، وبكرمه الذي بلغ الآفاق، وبحلمه وتواضعه، وبحضوره المُشرِق في زمن عاصف سياسيّاً وفكريّاً. فكان ملاذاً للناس، وعنواناً للهُدى، ومصدراً للعلم والبركة. وفي ظلال إمام كهذا، لا يليق بنا إلّا أن نُحيي ذكراه بما يُشبه أخلاقه، ونستلهم من سيرته ما نصلح به أنفسنا ومجتمعنا.
ومن بين تلك القيم الرضويّة المتألّقة، يبرز خُلقٌ نبيلٌ قد نهمله في زحمة الواقع، وهو خُلق «حُسن الجوار»؛ إذ يُلفِت الإمام الرضا (عليه السلام) أنظارنا إلى قيمة عظيمة في العلاقات الإنسانيّة، فيقول: «أحسِنْ مُجاوَرَةَ مَن جاوَرَك، فَإِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُكَ عَنِ الْجَارِ»[2].
ومن هنا، يكون حديثنا في هذه الجمعة المباركة عن هذه القيمة، التي تحتاج إلى تأكيد وتجديد؛ إذ بها يدخل الدفء بيوتنا، والرحمة أحياءنا، والسكينة مجتمعاتنا.
حُسن الجوار في الرؤية الدينيّة
أيّها الأحبّة، إنّ من أشدّ ما أوصت به شريعتنا الغرّاء في أخلاق المعاملة هو حُسن الجوار؛ فقد بلغ من عناية الإسلام بهذا الخُلق أن جعله ممّا يتكرّر التنبيه عليه من قِبل الوحي، حتّى قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام) يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ»[3].
فهذا الإلحاح الربّانيّ يكشف عن أنّ الجار ليس فرداً عابراً في الحياة، بل له حرمة ومكانة تضاهي القرابة، ويُبنى عليها معيار من معايير الإيمان.
وفي هذا السياق ندرك دقّة تعبير الإمام الرضا (عليه السلام) حين قال: «أحسِنْ مُجاوَرَةَ مَن جاوَرَك، فَإِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُكَ عَنِ الْجَارِ»؛ فليست المسألة هنا خُلقاً تطوّعيّاً أو نافلة من مكارم الأخلاق، بل مسؤوليّة شرعيّة يُسأل عنها العبد يوم القيامة، ممّا يكشف عن عمق ارتباط السلوك الاجتماعيّ بالعقيدة، وأنّ حسن الجوار ليس مجرّد تفضّل، بل واجب يُحاسَب عليه الإنسان، تماماً كما يحاسَب على الصلاة والصيام؛ لأنّ الجار في منطق الإسلام شريك في الأمن والطمأنينة والعيش الكريم.
عمق أثر الجوار في بنية المجتمع
أيّها الأحبّة، إنّ الجار حين يجد من جاره احتراماً، ويشعر منه بالعناية، ويأمن أذاه، تنشأ بينهما علاقة مودّة وسكينة وثقة متبادلة. وهذه العلاقة لا تقف عند حدود طرفَين، بل تنتقل آثارها إلى باقي أهل الحيّ والقرية، فيصبح الجوّ الاجتماعيّ مفعماً بالسلام والتراحم.
وتتجلّى صورة الجار الصالح في سلوكٍ يوميّ: في ردّ السلام، وفي السؤال عن الحال، وفي المواساة عند الشدائد، وفي مشاركة الأفراح، وفي غضّ الطرف عن الزلّات، وفي الإحسان إلى الأبناء والعيال... بل إنّ حُسن الجوار لا يعني فقط أن لا تؤذي، بل أن تُعين وتُكرِم وتغفر وتترفّق، بل وتصبر على أذى الجار، من أجل إدامة العلاقات، وعدم حدوث القطيعة، يقول الإمام الكاظم (عليه السلام): «لَيْسَ حُسْنُ الْجِوَارِ كَفَّ الْأَذَى، وَلَكِنَّ حُسْنَ الْجِوَارِ الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى»[4].
وحقّ الجوار لا يُنظَر فيه إلى الانتماء العقائديّ والمذهبيّ، بل هو شامل لمطلق الإنسان، مسلماً كان أم غير مسلم، فإنّ هذه القيم تتجاوز الحدود، لتصل إلى إنسانيّة العلاقة وجوار القربى والمكان، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «الجيران ثلاثة؛ فمنهم مَن له ثلاثة حقوق: حقّ الجوار وحقّ الإسلام وحقّ القرابة، ومنهم مَن له حقّان: حقّ الإسلام وحقّ الجوار، ومنهم مَن له حقّ واحد: الكافر له حقّ الجوار»[5].
غربة خُلق الجوار في عصرنا
أيّها المؤمنون، إنّ من المؤسف أن نشهد في كثير من مجتمعاتنا اليوم تراجعاً ملحوظاً في خُلق الجوار. فقد أصبحت العلاقة بين الجيران باردة، وفي بعض الأحيان منعدمة، وأحياناً يشوبها سوء الظنّ، أو المنافسة السلبيّة، أو النزاعات على أدنى الأمور وأتفهها.
هذا الواقع يفرض علينا أن نُراجع أنفسنا، ونسأل: ما الذي ضيّعناه من وصايا النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام)؟ كيف غلبت النزعة الفرديّة على روح الجماعة، وتوسّعت الهوّة بين البيوت، وتحوّلت الجدران من ساتر للخصوصيّة إلى حاجز للجفاء؟
ومسؤوليّة تغيير هذا الواقع لا تقع على جهة واحدة، بل تبدأ من كلّ فرد، حين يقرّر أن يُحيي هذا الخُلق في نفسه وأسرته. يبدأ بإلقاء التحيّة على جاره، ويتفقّد أحواله، ويشاركه في مناسباته، ويصفح عند الإساءة، ويعينه عند الحاجة، ويرفق به إذا أخطأ، فذلك أمر الله سبحانه في قوله :﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾[6].
حسن الجوار في هدي الإمام الرضا (عليه السلام)
إنّ مَن يتتبّع سيرة الإمام الرضا (عليه السلام)، لا يُفاجأ حين يرى هذا التركيز على خُلق الجوار؛ لأنّه (عليه السلام) كان في حياته اليوميّة -كآبائه (عليهم السلام)- مثالاً عمليّاً يُجسّد هذا المعنى. فقد كانوا (عليهم السلام) يعرفون جيرانهم ويكرمونهم، ويقضون حوائجهم، ويعينونهم في الشدائد، ولو كانوا من مخالفيهم؛ لأنّ الجوار عندهم ميثاق أخلاقيّ، لا يُلغيه اختلاف العقيدة.
وكان ممّا يُروى عن الإمام الرضا (عليه السلام) قوله: «ليس منّا مَن لم يأمَن جارُه بوائقَه»[7]، وهي كلمة جامعة، تُظهر أنّ مَن لا يأمن جارُه من شرّه وأذاه لا ينتمي إلى نهج أهل البيت (عليهم السلام)، بل يُنزَع عنه شرف الانتساب القيميّ إليهم؛ إذ إنّ الإيمان ليس ادّعاءً نظريّاً، بل هو التزام عمليّ يُترجَم في السلوك، وأولى ساحاته القريبة الجار، فإذا لم يسلَمِ الجار من الأذى، فذلك مؤشِّر على خلل عميق في الإيمان والسلوك، كما أنّ تعبير «ليس منّا» يُعَدّ من أشدّ أساليب التنبيه والتحذير في الروايات؛ لما فيه من نفي الانتماء العمليّ إلى خطّ الإسلام الحقيقيّ.
ختاماً
عباد الله، حُسن الجوار ليس نافلة من الأخلاق، بل فريضة اجتماعيّة تُبنى بها المجتمعات وتستقيم بها القلوب، وهو خُلق يؤهّل الإنسان لأن يكون في زمرة المسلمين الصادقين، كما نصّت عليه كلمات الإمام الرضا (عليه السلام).
فلنبدأ من أنفسنا، ولنُجالس أبناءنا على هذا الخُلق، ولنَجعل من ولادة الإمام الرضا (عليه السلام) مناسبة لتجديد هذا العهد، ولنُعيد لأحيائنا روح المحبّة والوئام.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المُقتدين بأخلاق آل محمّد (عليهم السلام)، وأن يعيننا على حُسن الجوار، وأن يُديم علينا نعمة الإيمان والألفة، ويختم لنا بخير، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
[1] الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه)، إنسان بعمر 250 سنة، ص336 - 337.
[2] ابن بابويه القمّيّ، فقه الرضا (عليه السلام)، ص401.
[3] القاضي النعمان المغربيّ، دعائم الإسلام، ج2، ص88.
[4] ابن شعبة الحرّاني، تحف العقول عن آل الرسول (صلّى الله عليه وآله)، ص409.
[5] النراقيّ، جامع السعادات، ج2، ص206.
[6] سورة النساء، الآية 36.
[7] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج2، ص28.